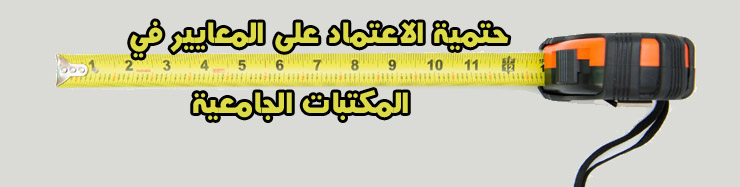التحول إلى النشر الإلكتروني حلول واقعيــة
عناصر البحث
(1) المقدمـــة
(2) تعريف النشر
الإلكتروني
(3) الفجوة الرقمية
والمحتوى الإلكتروني العربي
(4) مفهوم الناشر
في عصر المعرفة
(5) حلول واقعية
للنشر الإلكتروني
(6) مزايا النشر
الإلكتروني
(7) مشاكل النشر
الإلكتروني
(8) هل يقضي النشر
الإلكتروني على حب القراءة
(9) التسويق و
المتاجرةالإلكترونية للمحتوى
(10) كيف تخطط
لعملية التحول
(11) الخاتمــة
1-المقـــدمـــــة
نقف جميعاً شهوداً
أمام بداية حضارة جديدة، حضارة مجتمع ما بعد الصناعة، التي أقامتها تكنولوجيا
الآلة الجديدة، حيث يشير الكاتب المستقبلي الشهير ألفن توفلر Alvin Toffler في كتابه
تحول القوى Power Shift " إلى أن السيطرة على تداول وتدفق وتوزيع
المعرفة والوصول إليها هي محور الصراع في عصر ما بعد الصناعة" وبذلك هو يتنبأ
لنا بأن الكلمة الفاصلة في ذلك العصر هي المعرفة، و هذا يذكرنا بصيحة فرنسيس بيكون
الشهيرة و التي أطلقها في القرن السادس عشر بأن "المعرفة قوة"، تلك
الأقوال تنطبق على تلك الحقبة التي يحياها الإنسان والتي من أبرز سماتها ذلك
التسارع التكنولوجي الكاسح والسرعة في المستجدات العالمية، هذه المستجدات لم
نألفها من قبل، وهي تلقي علينا بظلالها وآثارها، بعض هذه الآثار ظاهرٌ والبعض
الآخر خفيٌّ، وبعضها مباشرٌ والآخر طويل الأجل ولكنه واسع الانتشار، والبعض يلقى
قبولاً عالميا والآخر يثير أو يجدد الشكوك العميقة التي كثيراً ما تكون لها آثار بعيدة
المدى.
من هذا المنطلق
نتناول ذلك المارد القادم في عالم الفكر و نشر الثقافة و الحضارة، إنه النشر
الإلكتروني موحياً في مدلوله على القالب الذي تشكلت فيه ثقافة مجتمع المعلومات
المعاصر، وهو بهذا يكون ضمن مئات القضايا التي تناولتها المؤلفات الغربية التي
تشير إلى البدايات والنهايات، مثل كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما، وكتاب صراع
الحضارات لذائع الصيت صموئيل هنتنجتون، وكتابي الموجة الثالثة وصدمة المستقبل،
لتدل على النهايات الورقية وبداية الإلكترونية، كما تنبأ بذلك لانكستر بظهور المجتمع اللاورقي في كتابه
الصادر عام 1978 بعنوان "نحو نظم لا ورقية للمعلومات
Toward paperless information society
وإنه لمن الغريب
حقا و المثير للدهشة، أن النداءات الآن كثرت نحو التحول الإلكتروني في كل مناحي
الحياة، فقد تغيرت مقولة شكسبير الشهيرة أكون أو لا أكون ( Be or not to Be ) إلى ( E or not to E ) لتكون البادئة E أو إلكتروني أو رقمي digital في كل الكلمات المتداولة
في هذا العصر رامزة إلى التغير الرهيب في النسق الاجتماعي و الثقافي.
ذلك لم يكن غريباً
علينا و نحن في مجتمع المعلومات أو المجتمع الرقمي أن نرى نتاجاً جديداً يولد من
رحم الثقافة الإلكترونية يطلق عليه النشر الإلكتروني
E-Publishing وهو الذى يستند على أدوات
هذا العصر من تكنولوجيا الحواسيب والاتصالات والشبكات وخصوصا شبكة الإنترنت ذلك
الماموث الذي غير مجرى الحياة من كافة الجوانب والذي تطور بشكل كبير ومتسارع، مما
أسهم في تطور بيئة النشر الإلكتروني وبالتالي سيكون تركيزنا على ذلك التأثير من خلال هذا
البحث.
وفي استعراضنا
لورقة البحث سوف نتناول تعريف النشر الإلكتروني بمزاياه وعيوبه ومشاكله كما نتناول
الحلول والواقعية له وكيف يخدم التسويق الإلكتروني البديل لطرق التسويق التقليدية.
2-تعريف
النشر الإلكتـرونـــي
إن النشر الإلكتروني يعني استخدام كافة إمكانات
الكمبيوتر (سواء أجهزة وملحقاتها أو برمجيات) في تحويل المحتوى المنشور بطريقة
تقليدية إلى محتوى منشور بطريقة إلكترونية حيث يتم نشره على أقراص ليزر (DVD-CDROM-VDC) أو من خلال شبكة الإنترنت. والمقصود
بطرق النشر التقليدية:
(1)
الكتب الورقية.
(2)
المادة الصوتية المقدمة على أشرطة كاسيت مثل الخطب
والمحاضرات والدروس والأناشيد وأي محتوى ثقافي عمومًا يقدم على أشرطة كاسيت صوتي.
(3)
المادة المسموعة المرئية المقدمة على أشرطة فيديو كاسيت
مثل المحاضرات والأفلام العلمية والتسجيلية واللقاءات التلفزيونية وبرامج
التلفزيون وغيرها.
3- الفجوه الرقميه والمحتوى
الإلكترونى العربى
يمر السوق العربي والعالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات بتحولات سريعة
وضخمة. ويتجه الاقتصاد العالمي إلى ما يُسمّى باقتصاد المعرفة (Knowledge Economy). وتتجه جميع الدول العربية إلى تبني تقنيات التعليم
الإلكتروني في تطوير أنظمتها التعليمية.
وتتجه دور النشر العربية إلى سد الفجوة الرقمية، واللحاق بالركب العالمي
حيث يعمل الناشرون العرب حتى زمن قريب في نشر الكتب الورقية فقط، ومع التطور
العلمي والتقني، وتطوير مهنة النشر بصفة خاصة، بدأ الناشر العربي يتحول إلى تنويع
طرق النشر لتشمل النشر الورقي والإلكتروني، وبصفة عامة أصبح موردًا للمحتوى بكافة
أنواعه، ومساهمًا قويًا في نشر المعرفة عن طريق المعلوماتية، مما يساهم في سد هذا
الفراغ الضخم للمحتوى الإلكتروني العربي والإسلامي.
ويتفق هذا التوجه مع السعي الدائم
والحرص الشديد –من قِبَل جهات عدة- على التواصل المعرفي والثقافي مع المواطن
العربي بكافة الوسائل والطرق. ومن المعلوم أن الآلة التكنولوجية أصبحت وسيلة
مناسبة للوصول إلى المواطن العربي لأهداف التعليم والتثقيف والتجارة وغيرها. كما
أنها تعدّ –من جانب آخر- طريقة مناسبة لمدّ جسور التواصل الثقافي والحضاري بين
العالم العربي والإسلامي وبقية دول العالم، وأن تكون واجهة عصرية تمثلنا ثقافيًا
وفكريًا أمام الآخر في عصر اختصرت فيه التكنولوجيا المسافات وألغت الحدود و حطمت الحواجز
بين الدول.
وفي الوقت الذي دخلت فيه دور النشر
العالمية منذ عشرون عامًا العالم الرقمي، ومعها دخلت كل هذه الثقافات والحضارات
عالم الحاسوب والإنترنت في صورة رقمية، إلا أن حجم التواجد الرقمي للثقافة العربية
والإسلامية ما زال يشكل نسبة ضئيلة ولا يتعدى 1% من حجم المحتوى العالمى على
الانترنت. إن هذه النسبه لا يمكن مقارنتها بنسبة تعداد سكان العالم الإسلامي (الذي
تخطى عدده المليار نسمة)، ويشكل حوالي 25% من إجمالي سكان العالم.
ولا يخفى على أحد حجم الاستثمارات
الضخمه على مستوى العالم في مجال المحتوى الإلكتروني؛ فعلى سبيل المثال، بلغ حجم
تجارة التعليم الإلكتروني على مستوى العالم (2-3 تريليون) دولار، عام (2001م).
لذلك، كان من المهم التركيز على صناعه النشر الالكتروني
في العالم العربي ودراسة واقعها وطموحاتها والعمل الجاد على سد هذه الفجوه الرقميه
التى تهدد حضاره أمتنا العربيه والأسلاميه بالأندثار والذوبان فى الحضارات الأخرى
وتهدد أقتصادياتنا فى عالم تحكمه أقتصاديات المعرفه..
4-
مفهوم الناشر في عصر المعرفة
إن الناشر هو
حلقة الوصل بين المؤلف والمبدع للمحتوى بكافة أنواعه من جهه وبين المستخدم أو
المتلقي من جهه أخرى. ويقع عبئ إعداد المحتوى وحتى خروجه في الصورة النهائية على
الناشر، و هو يتولى أيضًا تسويقه وترويجه وتوزيعه من خلال شبكات توزيع ومعارض
محلية ودولية. ولقد كان الناشر في الماضي موردًا للكتب والكتيبات والمجلات وغيرها
من المطبوعات الورقية، ومع التطورات الحالية ودخول العالم عصر المعرفة فإن الناشر
قد أصبح موردًا للمحتوى، حيث لا يقتصر دوره على الكتاب بل تعداه ليشمل صورًا عديدة
يقدم بها المحتوى من كتب ورقية وكتب إلكترونية ومحتوى إلكتروني على أقراص ليزر
وعلى أجهزة المحمول ومن خلال البوابات والمواقع على شبكة الإنترنت ويتطلب هذا
التطور الكثير من التغيرات في استراتيجيات دور النشر وأسلوب عملها وإدراج
التكنولوجيا الحديثة في وسائلها وأساليب تسويقها وتوزيعها ودعايتها لمنتجاتها.
e-
حلول واقعية للنشر الإلكترونـــي
يحدث فى كثير من الأحيان خلط بين النشر الألكترونى والنشر المكتبى. وقد
عرفنا الأول فى الفقرات السابقه أما النشر المكتبى فهو استخدام التقنيات الحديثه
فى الصف الألكترونى للكتب ومعالجتها تمهيدا لطباعتها ورقيا وهو يستخدم برمجيات خاصة مع حواسيب وطابعات ليزرية غير مكلفة تنتج
صفحات منظمة ومعدة بصورة جذابة، يمكن من خلالها التنفيذ والحصول على خطوط بأنواع
وأشكال مختلفة وحروف متنوعة، مع تزويقات فنية وهندسية تضفي مسحة جمالية على النص
المكتوب، إضافة إلى إمكانية إدخال الصور والمخططات والرسوم من مصادر أخرى عن طريق
الماسح الضوئي الذي يحلل الصور إلى إشارات رقمية أو عن طلب هذه الصور من برامج
أخرى.
ولقد أستفاد النشر الألكترونى من تقنيات النشر المكتبى من خروج النص فى
صوره ألكترونيه –وقبل تحويله الى أفلام للطباعه- لكى يتم معالجته ونشره ألكترونيا
سواء على أقراص ليزر أو من خلال شبكه الأنترنت. ولكن فى نفس الوقت فإن حلول
النشر الألكترونى لم تقتصر على ذلك بل تخطته الى أفاق أوسع نستعرضها فيما
يلى:
1-
تحويل الكتب الورقيه الى الملفات الألكترونيه الشهيره PDF :
أبتكرت شركه أدوبى الملفات (Portable Document Format – PDF ) والتى
تتميز بعدم أعتمادها على البرنامج التطبيقى ولا نوعيه الأجهزة أو نظام التشغيل
المستخدم. وأصبحت هذه االنوعيه من أشهر صور الكتب فى صورتها الألكترونيه. وتتم
عمليه تحويل أو رقمنه الكتب بطريقتين: أما بإدخال صفحات الكتاب كصور بإستخدام
الماسح الضوئى (Scanner ) ثم يحول
الى الصوره الرقميه PDF)) أو يتم أدخال الكتاب وصفه من
جديد على أحدى برامج معالجه الكلمات أو النشر المكتبى ومن ثم تحويله الى ملفات ( ( PDF .
2-
الكتاب الألكترونى E-Book :
هو برمجيه يتم تطويرها لعرض محتويات كتاب ألكترويا على
شاشه الكمبيوتر أو جهاز قارئ خاص e-book reader يشبه فى حجمه حجم الكتاب المطبوع كما يمكن عرضه
أيضا من خلال أجهزه الهاتف النقال الحديثه التى أصبحت تدعم الآن معظم أشكال النشر
الألكترونى. ويمكن عرض الكتاب الأكترونى من خلال المواقع علي شبكه الأنترنت كما
يمكن تخزينه وتغيله من خلال أقراص الليزر. وتعتبر ملفات PDF أحد أنواع
هذا الكتاب الألكترونى وأبسطها.
وتتوافر فى برنامج الكتاب الألكترونى مجموعه من
المواصفات والتى تميزها عن الكتاب الورقى تلخصها فيما يلى:
·
إمكانيه التصفح ألكترونيا من خلال متصفح برمجى يصل
الموضوعات من خلال الفهرس الرئيسى والفهارس الفرعيه للكتاب.
·
أمكانيه البحث للوصول لأى كلمه موجوده فى نص الكتاب.
·
أمكانيه عرض الصور والرسومات والخرائط فى صوره ألكترونيه
مع نص الكتاب.
·
إمكانيه الربط التشعبى (Hyper-Link ) بين الكلمات الأساسيه (Key words) الموجوده
فى نص الكتاب كما تشمل الأشاره الى قائمه المراجع المستخدمه فى تأليف الكتاب.
ويستخدم الربط التشعبى بربط المستخدم بمواقع أخرى على الأنترنت تحتوى على معلومات
أضافيه أو مفيده أو قواميس ومعاجم وغيرها.
·
أمكانيه الطباعه لأى جزء من نص الكتاب
·
أمكانيه أستخدام الحافظه للقص واللصق (Cut and Paste )
·
أمكانيه العلامه الألكترونيه Electronic Book Mark
3-
تحويل المناهج الدراسيه الى مناهج ألكترونيه:
غالبا ماتقوم عمليه التدريس بالطرق القليديه من خلال
كتابين لكل ماده: كتاب المدرس وكتاب الطالب. فكتاب المدرس يحتوى على الأهداف
التربويه وطرق التدريس والتدريب والتقويم لأداء الطالب وكتاب الطالب يحتوى على شرح
الماده والواجبات والتدريبات التى يؤديها الطالب سواء فى الفصل أو المنزل. وتحويل
المناهج الى الصوره الألكترونيه يتم بإعاده تأليف كتب المنهج الدراسى حيث يشارك
خبير الماده مع المصمم التعليمى الخبير فى الجوانب التربويه وطرق التدريس مع دمج
التقنيات وبعد ذلك يتولى فريق متخصص من المبرمجين وفنيين فى الوسائط المتعدده
إعداد الماده الألكترونيه. وتعتمد أحدث طرق التحويل الألكترونى للمناهج على تفتيت
المنهج الدراسى الى وحدات قائمه بذاتها تسمى العناصر التعليميه Learning Objects . كل عنصر تعليمي يحتوى على الأهداف التربويه للدرس وشرح بالوسائط
المتعدده ( الصوره والنص والصوت والفلاش والرسوم المتحركه) ثم التدريبات والتقويم.
ويتم الشرح من خلال تتابع الشرئح الألكترونيه للدرس ووجود التفاعليه أثناء الشرح
ومن خلال التدريبات والتقويم. وهناك أيضا نوع من العناصر التعليميه يحقق التفاعليه
بشكل كبير بين المستخدم والكمبيوتر من خلال المحاكاه ٍSimulation مثل المعامل الأفتراضيه للفيزياء والكيمياء والبيولوجى والرياضيات
وغيره. ومن الأمثله على المناهج الألكترونيه مشروع سكوول الذى تدعمه شركه أنتل
العالميه (www.skoool.com.eg ).
4-
تحويل القصص الورقيه الى قصص ألكترونيه وتفاعليه:
أدخل النشر الألكترونى الى عالم الخيال والقصص بكافه
أنواعها بعدا جديدا وهو أن تكون القصه مقروءة ومسموعه ومرئيه بل أيضا تتفاعل مع
المستخدم وخاصه الأطفال. وهو بذلك تعدى الأمكانيات التى توفرها أفلام الكرتون
والأعمال الأخرى للمسرح والسينما. بل ويمكن أعتبار أن هذه الأمكانيات هى أمتداد
لكل ذلك. إن مجال عمليه التحويل الألكترونى للقصص واسع ومتعدد الأبعاد ويغطى حجم
ضخم جدا من التطبيقات نوردها بإختصار فيما يلى:
1.
القصص المكتوبه والمسموعه حيث يتم عرض القصة مع الرسومات
والفلاش والصوت من خلال برنامج كمبيوتر يحاكى فى طريقة عرضه صفحات الكتاب الورقى
من ناحية الشكل وتقليب الصفحات.
2.
تحويل القصه الى رسوم متحركة مع الصوت أضافة ألعاب
ألكترونيه (Games ) تدور حول موضوع القصة
بالأضافة الى أسئلة ووسائل تنمية مهارات مثل التلوين والذاكرة وقوة الملاحظة
وغيرها.
3.
تحويل القصة نفسها الى لعبة تفاعلية (Game ) ويتطلب ذلك تأليف
سيناريو خاص بها وتخطيط المسارات المختلفة وأستخدام كافة الأمكانيات التفاعلية
والرسوم المتحركه والوسائط المتعددة لتحقيق الفائدة والمتعة من اللعبة.
5-
الدوريات والمجلات الألكترونيه:
هى نسخة رقمية من المجلة أو الدورية المطبوعة وتعرف
بأنها مرصد بيانات تمت كتابته ومراجعته وتحريره وتوزيعه ألكترونيا. وهى تقدم أما
على أقراص ليزر أو من خلال مواقع على شبكة الأنترنت. وقد وفر هذا التحول
الألكترونى مساحات ضخمة من التخزين لدى المكتبات على مستوى العالم. وهناك مقولة
أننا لوجمعنا كل ماكتبه الأنسان منذ بدأ الخليقة وحتى الآن على أقراص ليزر فسيكفيه
مبنى واحد مكون من ثلاثة طوابق.ولا تقتصر فائدة الدوريات الألكترونيه على مساحة
التخزين بل تتعداها الى الأمكانيات الفائقه فى البحث وأقتناء المحتوى بها وغيرها
العديد من مزايا النشر الألكترونى.
6-
الصحافه الألكترونيه:
طورت تقنيات النشر الألكترونى الصحافه والأعلام بشكل
مذهل. فعلى صعيد عمليه أصدار الصحف اليويمه والمجلات ومع أستخدام كافه تقنيات
النشر المكتبى فقد تم تطوير أنظمه تستخدم الأنترنت لربط المحررين ووكالات الأنباء
فى أى مكان فى العالم بإدارة النشر وميكنة عملية الأعداد للمقالات والتحقيقات
وتحقيقها ومراجعتها وحتى صدور أمر النشر وتنفيذه فى المطابع كل ذلك يتم فى ساعات
وفى دول متعدده بدون التقيد بمكان أآ كان على وجه الأرض. ومن الأمثله على ذلك
النظام المطبق فى دار الشرق القطرية بفروعها فى قطر ومصر وعدد كبير من الدول
العربية.
من جانب آخر فالصحفة أيضا أصبحت تصدر لها طبعة ورقية
وأخرى ألكترونية من خلال موقع خاص بها على شبكة الأنترنت ويمكن الدخول الى موقع
الصحيفة والبحث بمحركات البحث بالمواضيع المختلفة للمقالات المنشورة. وهناك صحف
ألكترونية فقط ولا تصدر طبعات ورقية مثل "مجتمع المعلومات المصرى " وهى
تصدر من خلال الموقع الخاص بها.
7-
الخرائط الألكترونيه وأنظمه المعلومات الجغرافيه ( GIS ):
إن الخرائط التقليديه معروفه بتكلفتها الباهظه فى
الأعداد والطباعه وحجم كتبها الورقيه وخاصه إذا كان يصاحبها معلومات ترتبط بأماكن
مختلفه على هذه الخرائط. وبفضل النشر الألكترونى تحولت هذه الخرائط ليس فقط الى
خرائط رقميه بل تعدتها لتكون أنظمه معلومات جغرافيه تربط المعلومات بالأماكن
المختلفه على هذه الخرائط. وظهرت نتيجه لذلك تطبيقات ضخمه ورائعه لم يكن من الممكن
تنفيذها من قبل. ومن أشهر هذه التطبيقات:
1.
تحديد موقع سياره على الخريطه بمساعده الأقمار الصناعيه
بل وتتبع مسارها.
2.
ربط المعلومات بخريطه منطقه معينه مثل كثافه السكان,
توزيع المساحات الخضراء, توزيع الخدمات, وغيرها وأستخدامها للدراسات الخاصه بهذه
المنطقه وأساليب تطويرها.
3.
ربط خريطه منطقه معينه بالأماكن السياحيه والخدمات
وغيرها.
4.
التخطيط لأنشاءات يتم توزيعها فى منطقه معينة مثل ابراج
شبكات المحمول للوصول لأفضل تغطية مع الحد الأدنى من التكلفه.
5.
الأستخدامات العسكريه.
إن عدد التطبيقات وتنوعها فى هذا المجال غير محدوده.
وهناك العديد من دور النشر المتخصصه فى مجال الخرائط قد مرت بمرحلة التحول الى
الخرائط الرقمية للمدن والمناطق المختلفة وأنتجتها على أقراص ليزر ومن خلال مواقع
على الأنترنت وكخدمه خاصه للمشروعات وأتسعت حجم التطبيقات من مجرد خرائط ورقيه الى
عالم واسع من التطبيقات
8-
المدونات Blogs:
المدونه هى موقع شخصى على شبكه الأنترنت يقوم صاحبه
بكتابه تدوينه فيه, والتدوينات هى مدخلات يقوم المدون بإضافتها الى محتوى مدونته.
وهذه المدخلات أما أن تكون نصوصا أو صورا أو قيديو أو أى شكل من أشكال المعلومات.
وتعرض المعلومات بتسلسل زمنى تنازلى. وقد اسهم فى أنتشار هذه التقنيه كومها وفرت
أرضيه هائله للتواصل والتعبير عن الآراء وعن القدره الأبداعيه فى مختلف المجالات؛
بعيدا عن التعقيدات الأدارية وعن مختلف وسائل الرقابة الرسميه. وعلاوة على وجود
قوالب جاهزة لتقديم المدونات فإن أطلاقها عمليه سهلة ولا تتطلب وقتا وجهدا كبيرا.
وفى الحقيقه أن إحداث المدونات لم يعد متوقفا على الأفراد بل تجاوزه الى هيئات ومؤسسات(مراكز أبحاث, شركات, أتحادات,
جمعيات مدنية,جرائد, مجموعه شبابية) وهو ماجعلها مصدرا للأخبار والأراء وأصبحت
تكمل وسائل الأعلام التقليدية حيث وفرت المدونات الألكترونية أمكانيات هائله
للتواصل ولتبادل الأفكار والمعلومات لمختلف الأشخاص وفى مناطق عديدة من العالم
وتوفر لديها محتوى ضخم ومتنوع. وهو مادفع ناشرين الى الأتفاق مع اصحاب بعض المدونات وتجميع أعمالهم ونشرها ورقيا
وألكترونيا.
9-
الويكيز Wikis :
موقع يتيح للمستخدم أن يضيف أو يعدل أو يمسح أى محتوى
داخل صفحات الموقع, مع أمكانية ان تخضع تلك التغيرات الى رقابة من قبل إدارة
الموقع قبل أتاحتها لباقى المستخدمين. إن كلمه ويكى تعنى سريع فى لغة سكان جزيرة
هاواى ومن هنا أرتبط الأسم بالتدوين المباشر والسريع على الشبكه العنكبوتية ومن ثم
كان للويكيبيديا دور مهم فى نشر مفهوم تشارك الخبرات وبناء العلم وتصحيحه أو
مايعرف بمفهوم خلايا النحل.
والويكيبيديا هى مشروع موسوعة متعدده
اللغات على الويب ذات محتوى حر, تشغلها مؤسسه وكيميديا وهى منظمه غير ربحية.
والويكبيديا موسوعه تمكن لأى مستخدم تعديل وتحرير ماتحتويه من معلومات وأنشاء
مقالات جديدة. وعلى مدى 7 سنوات تم تعبئة 10 ملايين مقالة وب 250 لغة مختلفة.
والويكيبيديا العربية تحتفل بوصول عدد المقلات بها لقرب 100,000 مقلة باللغة
العربية خلال عام 2009.
وبعد أن تناولنا حلول النشر الألكترونى نتحدث عن كيفية
نشر المحتوى الألكترونى. فى الواقع توجد خمسه قنوات رئيسيه لنشر المحتوى
الألكترونى هى:
1.
تحميل المحتوى الألكترونى على أقراص ليزر ثم نسخه
وتغليفه وتوزيعه.
2.
وضع المحتوى الألكترونى على مواقع أو بوبات على شيكه
الأنترنت مع تحديد كيفيه التعامل معه سواء بالتنزيل Download أو السماح بالأطلاع عليه فقط من خلال الموقع أو البوبه مع تحديد
طريقه الدفع اذا لم يكن مجانى.
3.
تنزيل المحتوى الألكترونى من الأنترنت من خلال مواقع
خاصه به الى أجهزه قارئ الكتاب الألكترونى E-book Reader .
4.
تنزيل المحتوى الى أجهزه المحمول من خلال شبكات مزودى
الخدمه أو من خلال الأنترنت.
5.
من خلال القنوات الفضائيه التى تعرض المحتوى من خلال
شاشتها بإستخدام أجهزه الكمبيوتر فى أستديوهاتها. وستتطور هذه الخدمه مع ظهور البث
التفاعلى للقنوات الفضائيه والذى سيظهر قريبا.
f-
مزايـا النـشــر
الإلكتــرونــــي
بالرغم من القناعة لدى الكثير بأن متعة القراءة لا تتحقق إلا بالاطلاع من
الكتاب الورقي وأن القراءة من شاشات الكمبيوتر أو الكتاب الإلكتروني لا تحقق نفس
الغرض إلا أنه يجب أن تأخذ في عين الاعتبار المزايا الفائقة التي يحققها النشر
الإلكتروني بالنسبة للناشرين ويمكن تخليص هذه المزايا في النقاط
التالية:
(1)
أنخفاض تكلفه النشر: فى النشر الألكترونى نلاحظ انعدام وجود تكلفة الطباعة
على الورق والتجليد والتغليف للناشر مع وجود تكلفة زهيدة جدًا للطباعة لأقراص
الليزر وتكلفتها لا تقارن بتكلفه طباعه الكتب وخاصة المجلدات الكبيرة والموسوعات.
(2)
تضائل تكلفه التخزين والشحن: إن تكلفة
تخزين ونقل وشحن الكتب الورقية ضخمة مقارنة بالنسخ الإلكترونية سواء على أقراص
الليزر أو التي يتم تحميلها من خلال المواقع والبوابات الإلكترونية,
(3)
عدم الحاجه لموزعين: في حالة تسويق وتوزيع المحتوى الإلكتروني من خلال
البوابات والمواقع تكون العلاقه بين الناشر والمستخدم النهائي فلا حاجة لوكلاء ولا
موزعين ويتم شراء وتحميل المحتوى مباشرة من الإنترنت ودفع قيمته بواسطة بطاقات
الائتمان، مما يساعد على تخفيض سعر المستهلك وتشجيع شراء كميات كبيرة.
(4)
الإنتشار:إتاحة المحتوى الإلكتروني من خلال الإنترنت يعني السرعة
الفائقة في النشر وإمكانية الحصول عليه في أي مكان في العالم، وذلك بمجرد نشره على
الموقع أو البوابة وبدون وجود أي حواجز مما يتيح فتح أسواق كثيرة يصعب الوصول
إليها بالطرق التقليدية والنشر الورقي.
(5)
طرق تسويق مبتكره: حيث يتم الاستفادة من محركات البحث وطرق التسويق
الإلكتروني في الترويج للمحتوى الإلكتروني والإشارة إلى موقع تواجده على الإنترنت
والناشر الذي يقدمه.
(6)
الأستمراريه: فالكتاب الألكترونى لاتنفذ طبعاته من السوق وهى ميزه
لاتتوفر فى الكتاب الورقى
(7)
سرعه إعداد الأصدرات الجديده: نتيجه لسهوله الأضافه والتعديل والحذف للمحتوى
الألكترونى يمكن أصدار أكثر من طبعه للكتاب فى فترات متقاربه.
(8)
المحافظه على البيئة: من خلال الحد من التلوث الناتج عن نفايات تصنيع الورق
أما بالنسبة
للمستخدم: فيتمتع
المحتوى الإلكتروني بالمزايا التالية:
(2)
سهولة البحث في داخل المحتوي ومعالجته إلكترونيًا بالقص واللصق
والتعديل والإضافة.
(3)
وجود إمكانية الطباعة للأجزاء التي يرغبها المستخدم حتى يتمتع بقراءتها كنسخة
ورقية.
(4)
أستخدام الوسائط المتعدده: حيث تتوفر إمكانية تقديم المحتوى في صورة برنامج تفاعلي
بالصوت والصورة والرسوم المتحركة والفيديو ترتفع القيمة والفائدة الحقيقية للمحتوى
بدرجة كبيرة لفائدة المستخدم وهذه الميزة تظهر بوضوح في القصص والمناهج التعليمية
والموسوعات العلمية وغيرها الكثير من المؤلفات.
(5)
أمكانيه التعرف على معانى الكلمات والمصطلحات: وذلك من خلال الروابط المتصله بالقواميس والمعاجم.
(6)
سهولة استخدام المحتوى الإلكتروني في التعليم والتدريب: في المدارس والجامعات ومراكز التدريب حيث يتيح للمدرس
والأستاذ والمدرب تناول مادة المحتوى بصورة أسهل وأيسر في التحضير والشرح في الفصل، كما يسهل تبادل الدروس المعدة
بين المعلمين والأساتذة الكترونيا من خلال شبكة الإنترنت.
(7)
توفير الحيز المكانى: حيث لايحتاج الكتاب الألكتروني الى رفوف أو مساحلت
كبيره للتخزين فقرص الليزر يمكن أن يتسع لعدد 500 ألف صفحه من النصوص.
(8)
النشر الذاتى: يستطيع المؤلف نشر عمله مباشره على الموقع الخاص به
دون الحاجه للتعامل مع دور النشر.
e-
مشاكل النشر الإلكترونــي
يواجه النشر الألكترونى عده مشاكل أهمها:
(1)
أنتهاكات حقوق الملكيه الفكريه للناشرين والمؤلفين: وتعتبر هذه أكبر مشكله تواجه النشر الألكتروني لسهوله
نسخ المحتوى الألكترونى مقارنه بالكتاب الورقي وعدم وجود ضوابط تحكم القرصنه على
شبكه الأنترنت حيث يتم نشر المحتوي المسروق بدون الرجوع للمؤلف. وقد بدأ ظهور
تقنيات جديده للحمايه الألكترونية للمحتوى على أقراص الليزر ومن خلال شبكة
الأنترنت وتحدد ترخيص الأستخدام لشخص واحد وعلى جهاز واحد. هذا بالأضافة الى
التحرك على مستوى الشركات وجمعيات المجتمع المدنى والحكومات للتصدى لظاهره
القرصنه. وفى أعتقادى أن للأعلام وأنظمه التعليم
دور كبير فى فى نشر وتأصيل ثقافه أحترام حقوق الملكية الفكرية.
(2)
ضروره توفر أجهزه لأستخدام المحتوى الألكترونى: مثل جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكتاب الألكترونى أو
الموبيل بينما الكتاب الورقى لايحتاج إلا أقتنائه. ولكن هذه الأجهزه أنتشرت الآن
أنتشارا كبيرا ولها أستخدامات كثيره ومتعدده ليست قاصره على أستخدامت الكتاب
الألكتروني.
(3)
صعوبه القراءة من الشاشه للأجهزه الألكتروني: فهى بلا شك غير مريحه للعين مثل الكتاب الورقى
بالأضافه الى أنها لاتعوض متعه القراءه من الكتاب الورقي. ولكن هناك دراسات تؤكد
أن الجيل الجديد لا توجد لديه هذه المشكله بالأضافه لتطور أنواع الشاشات
وتقنياتها. بالأضافه الى وجود أمكانيات الطباعه للمحتوى الألكترونى للتمتع
بالقراءه من الورق.
(4)
التسويق الألكترونى للمحتوى: فبالرغم من كل المغريات التى يظهرها النشر الألكترونى
فما ذال هناك الكثير من العمل المطلوب لتسويق المحتوى ألكترونيا من ناحيه توفير
بوابات ومواقع لتسويق وبيع المحتوى من خلال الأنترنت وخاصه فى الدول العربيه
ومايصادفها من مشاكل تتعلق بحماية المحتوى وأنظمه الدفع الألكترونى وهو ما يتطلب
تضافر الجهود للنهوض بهذه الصناعه. وفى خلال الأيام الماضيه أضهرت شركه جوجل وهى
من أكبر شركات التسويق الألكترونى فى العالم أهتماما كبيرا بالمحتوى الألكترونى
العربى.
(5)
هل يقضي النشر الإلكتروني على حب
القراءة
إن أول كلمة
نزلت في القرآن الكريم: (اقرأ)، قال الله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي
خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم
يعلم).
فالقراءة تحتل
مكان الصدارة في توعية الإنسان وزيادة معارفه وإدراكه للعالم الذي حوله ولدينه
ودنياه.
لذا كان من
الضروري أن نهتم بغرس حب القراءة وعادتها السليمة في أطفالنا منذ الصغر – فقد
أثبتت الدراسات أن القراءة تساعد في تنمية ذكاء الطفل. لأنها الوسيلة الرئيسة التي
يستطيع من خلالها الطفل أن يستكشف البيئة من حوله. فهي تعد رافدا مهما للرقي
والتحضر. بل قبل ذلك هي وسيلة للوعي والتلقي، ومن هذا المنطلق تحتاج إلى أن نعرف
أهميتها وخطورة غيابها. فالأطفال عماد المستقبل ومنجم الفكر و يجب أن نقدم لهم
عناية خاصة ولعقولهم اهتمام بالغًا .. فالطفولة تعتبر من أهم مراحل البناء الفكري
وأفضل المراحل العمرية لتعليم واكتساب المهارات، علمية كانت أو معرفية.
ورغم ذلك نجد
أن الاهتمام بالقراءة ضعيف جدًا في بيوتنا العربيه، والحقيقة مؤلمة فيما أشارت
إليه الإحصائيات. إذ تقول إحصائية منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو): إن
متوسط قراءة الطفل في العالم العربي لا يتجاوز 6 دقائق في السنة خارج المنهج
الدراسي رغم ما للقراءة والمطالعة خارج المنهج من أثر كبير على المستوى التعليمي
للطالب، ويقرأ كل 20 عربيًا كتابًا واحدًا بينما يقرا كل بريطاني 7 كتب أي ما
يعادل ما يقرأه 140 عربيًا ويقرأ كل أمريكي 11 كتابًا أي ما يعادل ما يقرأه 220
عربيًا يا للأسف. وفي المقابل يعد معدل ما يقضيه الطفل العربي أمام التلفاز أعلى
مما هو عنه الطفل الأمريكي والأوروبي.
والأرقام
العالمية تطل علينا بحقائق محبطة حين تخبرنا بأبعاد المشكلة بشكل مقارن ومحزن،
تقول الأرقام:
·
الطفل الأمريكي: نصيبه من الكتب في العام 13260 كتابًا.
·
الطفل الإنجليزي: نصيبه من الكتب في العام 3838 كتابًا.
·
الطفل الفرنسي: نصيبه من الكتب في العام 2118 كتابًا.
·
الطفل الإيطالي: نصيبه من الكتب في العام 1340 كتابًا.
·
الطفل الروسي: نصيبه من الكتب في العام 1485 كتابًا في
العام.
أما الطفل
العربي فلا نكاد نجد له رقمًا ولو هزيلا يمثل نصيبه في عالم الكتب
وعلى الرغم من
حرصنا على أن نعلم أبنائنا القراءة وحرص المعلمين في المدارس على ذلك الأمر الذي
يستغرق سنوات من الجهد والعناء إلا أنه بعد أن يتعلم الطفل القراءة . تجده لا يقرأ
!!! وتجد الآباء والأمهات يعدون تعليم المدرسة هو الأهم وأن المطالعة وكتب القراءة
الجانبية من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
كيف تبدو
الصورة الراهنة لعالمنا اليوم في ظل التطور التقني الهائل والذي نشهد تغييرات
كبيرة في قطاعه بين الفينة والأخرى؟ لعلنا نجد الجواب فيما أورده جي – بولتر في
معالجته لحضارة الغرب في عصر الكمبيوتر 1989م. إذ قال "تضخم هائل في عدد
السكان، وندرة في المصادر، وتدهور في البيئة، وربما ينفرد جيل هذا العصر في أن
مشاكله وبشائر نجاحه تتأتى من مصدر واحد، الإنجازات الخارقة للعلوم والتقنية، وإذا
ما بقيت العوامل الأخرى ثابتة فإن الرجل والنساء ليسوا أكثر من أسلافهم جشعًا أو
عنفًا، أو شفقة، أو حماقة، لكنهم يجدون أنفسهم قد سيطروا على تقنية تزيد من
قدراتهم على التعبير عن هذه الخصائص التي هي إنسانية إلى حد بعيد. إن التقنية تمكنهم
من إعادة تشكيل الطبيعة لتلاءم احتياجاتهم وتعديلها إلى أقصى حد ممكن من تصوراتهم.
وإذا كان
المستقبل سيستمر في إبراز دور الاتصال في عملية التطور، وتأكيده على أهمية تحريكه
للمعلومات والأفكار، فلابد للعالم النامي لكي يتطور أن يأخذ في الحسبان قضية تقنية
الاتصال على أنها قضية مركزية ليس لأجل التطور وحسب بل من أجل البقاء على الحياة
امتثالا لمقولة توني أو تينكر من جامعة هارفرد: "على الإنسان أن يختار بتعقل
خطي مستقبله خشية أن يرقص رقصة الديناصور، وإذا ما كان الإنسان قد عاش على هذا
الكوكب شهرًا أعظم واحد، فإن الديناصور قد عاش 40 شهرًا أعظم ثم انتهى به الأمر
إلى الانقراض.
وإذا كانت الأسس
المادية للكتاب هى أول ما يواجه القراء، فإن لهذا الجانب من حسن المظهر وجمال
الشكل ما يجتذب القارئ ويجعله يأخذ طريقه إلى يده ثم إلى نفسه وعقله، وإلا فإن
الكتاب سوف يبقى حبيسا في رفوف المكتبة ومخازن دور النشر، ولهذا فإن الأسس المادية
للكتاب أصبحت في العالم المعاصر موضوع اهتمام الخبراء والفنيين في صناعة الكتاب في
الدول المتقدمة، وقد استعان هؤلاء الخبراء بعلم النفس في بحوثهم ودراساتهم لكل
مظاهر الجوانب المادية للكتاب.
فتأثير القراءة
والكلمة المكتوبة – كما يرى ماكلوهان – بدأ منذ اللحظة التي أنجز فيها جوتنبرج
ابتكاره للحروف المتحركة والمطبعية، لأنها وسيلة اتصال جديدة في شكلها وطبيعتها
وانتشارها. وقد ظهرت لكي تؤدي دورها المؤثر في التاريخ والحضارة وتغيير الإنسان
والمجتمع، ومع أن الجميع قد أدركوا أن ظهور المطبوع كان إيذانا بظهور تغيرات
خطيرة. إلا أن هذه التغيرات تأخذ – في نظرية ماكلوهان – شكل ثورة كاملة في جميع
المجالات، غيرت ملامح المجتمع الإنساني، وبدلت خصائص نفسية كثيرة لدى الإنسان،
وشكلت علاقات جديدة، وخلقت أشكالا اجتماعية جديدة من خلال تراكم التأثيرات
والتفاعلات، ومن خلال عمليات البناء والهدم معًا.
ويرى ما
كلوهان: "أننا نفتقر إلى فهم التأثرات النفسية والاجتماعية للمطبوع، مما يحير
أي دارس للتاريخ الاجتماعي للكتاب المطبوع، فمن النادر على مدى الخمسة قرون
الماضية وجود ملاحظات أو فهم واضح لتأثيرات المطبوع في وعي الإنسان وإدراكه".
إن هذه التقنية
والحلم الجمي مازالا في بدايتهما، وما زال هناك من يعارض هذه التقنية، إما عن جهل
بما توفره من إمكانات، وإما لعدم قدرتهم على التعامل مع التقنية الحديثة مقابل
عادات تأقلموا معها وألفوها. فهذا بريان أو جير الموظف في مكتبة روكفيل العامة
بولاية ميريلاند يراهن على أن الكتاب سيصمد. ويقول: "أريد شيئًا في إمكاني أن
أحمله معي في الحافلة، أو أقرأه في وقت متأخر من الليل أو أحمله معي إلى الشاطئ،
وينبغي أن يكون رخيص الثمن ويقدم المعلومات. وهذا ما تفعله الكتب والمجلات".
وإذا كان براين
يعترض على الكتاب الإلكتروني لأمور تعد منطقية لمن لم يطلع على التطورات الجارية
في هذا المجال، فإن هذه المدرسة تورد أسبابا أخرى ترى من وجهة نظرها أنها جوهرية
وكافية للتعلق بالكتاب الورقي والتشبث به، يقول السيد إيريك واليوس، وهو رئيس
تنفيذي لأحدى الشركات المهتمة بالكتاب الإلكتروني: في الأسبوع الماضي جلسنا مع
مديرة إحدى المدارس لبحث إمكان توفير نظام كتاب إلكتروني لطلبتها. وبعد نقاش مطول
وقائمة كبيرة من الأسئلة عن الموضوع كان ملخص رد فعل المديرة هو قولها: "أنت
بحاجة إلى أن تفهم أن معظم طلبتنا ليسوا بالذكاء بالقدر المطلوب لفهم هذه الأجهزة
الفنية، ولذلك لن يكون لديهم الاستعداد لمثل هذا الشيء". ويضيف إيريك
"حسنًا . بإمكاننا مناقشة هذا المنظور قليلاً باحثين درجة الذكاء الفني
المطلوب للكتاب الإلكتروني محل البحث وما يتضمنه من إتقان لزرين (مفتاحين) وعدد
قليل من الأيقونات، والمهم أنه، وخلال عرض لمجموعة من الأطفال من الصف الرابع
الابتدائي ولمدة عشر دقائق، عرف هؤلاء الأطفال خلالها أكثر مما عرفت عنه مدرستهم.
إن الكتاب
والإنترنت لن يلتهم أحدهما الآخر ولكنهما يتوافقان إلى أبعد الحدود لأن المبدأ
واحد هو المشاركة في الفكر والمعلومات. ويجب ألا نكون من أعداء الكتب الورقية بل من مؤيدي المشاركة
بأي شكل كان. وها هي الإنترنت تحقق أقصى إمكانيات المشاركة على المعرفة، ففي البدء
ظهرت الإنترنت كأداة للمشاركة في المعلومات بصورتها الأساسية رغم أنها لاحقا بدأت
تقدم كل شيء كالترفيه والتجارة وغير ذلك، وتترسخ هذه الفكرة لدى كل من يسعي من
متصفحي الإنترنت للعثور على مادة ذات قيمة عالية مثل المحتوى الفني والأدبي
والثقافي ودخلت الصورة والصوت والفيديو لتضيف كل هذه الحيوية لمحتوى الويب.
فالكتاب الألكترونى والكتاب الورقى وجهان لعمله واحده هى المحتوى ولن يقضى النشر
الألكترونى على الكتاب الورقى ولا حب القرآءة بل سيقوم كل منهم بدوره فى بناء واقع
جديد فى عصر المعرفه.
9-
التسويـــق والمتاجرة الإلكترونية
للمحـتـوى
e-Business and e-Commerce for Contents
التسويق الألكترونى يعنى أستخدام الأنترنت بكافهة
أمكانياته للترويج لسلعة أو منتج. وله وسائل كثيرة منها الحملات الدعائية بالبريد
الألكترونى والمواقع التسويقية والأعلانات الألكترونية على المواقع التى عليها عدد
كبير من الزوار ومن أشهر الشركات التى تقوم بذلك شركة جوجل العالمية. وهى تستخدم
أمكانيات فائقة لمعرفة نوعية الزوار للمواقع التى تضع عليها أعلاناتها وتوزيعهم
الجغرافى وبيانات أحصائية كاملة عنهم وبذلك تتمكن من توجيه الأعلان المناسب لهم.
أما المتاجرة الألكترونية فتعنى البيع والشراء من خلال
شبكة الأنترنت, وبشكل عام فهى تغطى كافة المعاملات التجارية وتبادل المعلومات ويتم
تنفيذها بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات سواء بين الشركات وبعضها ( Business to Business-B to B ) أو بين الشركات وعملائها (Business to Customer-B to C ).
إن أستخدام هذه التقنيات الحديثة فى التسويق والمتاجرة
للمحتوى عموما – سواء ورقى أو ألكترونى- أصبحت ضروره يفرضها واقع السوق العالمى
وتطوراته. والحد الأدنى هو ضرورة وجود موقع الكترونى لكل دار نشر مع الأستخدام
المكثف للبريد الألكترونى كبديل للفاكس والوسائل التقليدية الأخرى. وفى مجال تسويق
والمتاجرة للمحتوى الألكترونى فهناك وسيلتين أساسيتين هما:
·
أنشاء موقع لنشرالمحتوى الألكترونى مجاننا والأعتماد على الدخل الذى يدخل
للموقع مقابل الأعلانات التى تضعها شركات الأعلان الألكترونية المتخصصه (مثل شركة
جوجل). وتسمى شركة جوجل البرمجيات الخاصة بالأعلانات (Adware ) ويتحقق به أرقام ضخمة للمواقع التى يدخل عليها
عدد كبير من الزوار.
·
أنشاء أو الأشتراك فى مواقع البيع المباشر للمحتوى الألكترونى عن طريق
التنزيل (Down
Load ) أو الأشتراكات الشهرية أو
السنوية للأطلاع والبحث المفتوح. وغالبا مايكون نظام الدفع عن طريق البطاقات
الإتمانية.
ومن الممكن دمج الأمكانيتين فى موقع واحد. ومن أشهر الأمثلة على مثل هذه
المواقع:
(3)
موقع فكر راما الذى أنشأته وزارة الأتصالات والمعلزمات المصرية
10-
كيف تخطط لعملية التحول
بعد أن أستعرضنا فى هذه الورقه النشر الألكترونى من
جوانبه المختلفة يبقى السؤال الملح لكل ناشر وهو كيفية التخطيط فى دار النشر
الخاصة به لعملية التحول الألكترونى.
لكى يدخل أنتاج وتوزيح المحتوى الألكترونى جنبا الى جنب
مع أنتاج وتوزيع الكتب فإن هناك تطوير يجب أن يحدث فى أستراتيجيات المراحل الثلاثة
التى يمر بها العمل داخل دار النشر نستعرضها فيما يلى:
أولا: مرحلة التأليف
يجب أن يتم التخطيط عند تأليف المحتوى أنه سيكون هناك
أصدراة ورقية وأخرى ألكترونية. فالمؤلف حين يؤلف يضع فى الأعتبار الطريقة التى
سيعرض به عمله الأبداعى سواء كان كتاب ورقى أو محتو ألكترونى يعرض على قرص ليزر أو
من خلال شبكة الأنترنت أو من خلال المحمول فلكل خواصه وأمكانياته. ويوفر هذا
التفكير من البداية جهد ضخم وتكلفة عن حالة مايبدأ المؤلف بالأصدارة الورقية ومنها
يعدل للأصدارة الألكترونية. وفى بعض الأحيان يقوم المؤلف بعمل نوع من التوازن
وترتيب الأدوار بن النسخة الألكترونية والنسخة الورقية بحيث يكمل كل منهما الآخر
ويحدث لك فى حالة صدور طبعة ورقية يصاحبها قرص ليزر مثلا. وليس شرطا فى هذه الحالة
أن يكون محتوى النسخة الورقية مطابق للنسخة الألكترونية فالمهم تعظيم الفائده
بتحقيق أكبر أستفادة من كل من الطبعتين.
ثانيا: مرحلة الأنتاج
يمر الكتاب الورقى بمراحل الأدخال والصف والتنسيق
والمراجعه قبل الدخول لمرحلة الطباعة ويمكن الأستفاده بهذه المراحل فى الحصور على
نسخة الكترونية من نص الكتاب يتم الأستفادة بها فى أصدار الكتاب الألكترونى حيث كل
أنظمة النشر المكتبى المستخدمة فى أعداد الكتاب الورقى يمكنها أن توفر ذلك. ولكن خط أنتاج
الكتاب الألكترونى يختلف عن ذلك بالنسبى للكتاب الورقى. وهناك ثلاثة أختيارات
للتخطيط لذلك بدور النشر:
·
أنشاء وحدة للنشر
الألكترونى بدار النشر تشمل المبرمجين والفنيين والأدوات البرمجية اللآزمة
والأجهزة والأتصال بالأنترنت وأساليب الحماية الألكترونية للملكية الفكرية ويفضل
الأستعانة بإستشارى للإعداد والتخطيط لهذه الوحدة على أسس علمية سليمة وبأقل
تكلفة.
·
تحالف شركة تكنولوجيا
معلومات متخصصة مع دار النشر لأنتاج مشترك فى النشر الألكترونى مع توفر المحتوى
لدى دار النشر.
·
تعاقد دار النشر مع
شركة تكنولوجيا معلومات لتنفذ لها مشروعات النشر الألكترونى لحساب دار النشر وعلى
حسب الحاجة.
ثالثا: مرحلة التسويق والتوزيع
إن
الكتاب الورقى له أساليبه المعروفه فى التسويق والتوزيع من ناحية تكوين شبكات للوكلاء
والموزعين وحضور معارض الكتب على مستوى الدول العربية والعالم. وتقوم أتحادات
الناشرين المحلية والعربية والدولية بدور هام فى ذلك.
لكن
للمحتوى الألكترونى نجال مختلف كما أوضحنا فى الفقرة التاسعة عن التجارة
الألكترونية. والوسيلة التى ينتج بها المحتوى الألكترونى هى التى تحدد أسلوب
تسويقه:
·
المحتوى الألكترونى
الذى ينتج على قرص الليزر المصاحب للكتاب يغلف مع الكتاب و يتم تسويقه معه.
·
المحتوى الألكترونى الذى ينتج على قرص الليزر
كمنتج مستقل يتم تغليفه توزيعه خلال نفس قنوات توزيع الكتاب.
·
المحتوى الألكترونى
الذى ينتج ليوزع من خلال المواقع والبوابات على شبكة الأنترنت فيستخدم أساليب
التسويق الألكترونى السابق شرحها.
إن التخطيط السليم
لعملية التحول يمكن أن تؤدى الى طفرة فى أرباح دار النشر بإنفتاحها على العالم
أجمع و الأستهانة بذلك بالأعتقاد الذى يغلب على عدد من الناشرين بأن القضية كلها
لاتعدوا تعيين مبرمج!! قد تؤدى بها الى خسائر كبيرة وضياع رغبتها فى التطوير وهذا
ما عدث مع عدد من دور النشر العربية.
11-
الـخــاتـــــــمة
تم
خلال هذا البحث تعريف النشر الألكترونى وبيان مزاياه وومشاكله كما تم تقديم حلول
واقعية وتطبيقات عملية ومفيدة له. وقد وضح البحث خطورة الفجوة الرقمية التى يعانى
منها العالم العربى والأسلامى نتيجة
لتضائل حجم المحتوى اللكترونى العربى على مستوى العالم. أوضحت الدراسة أن خطر
النشر الألكترونى على حب القرائة هو تخوف غير مبرر فالنشر الألكترونى والورقى
وجهان لعملة واحدة هى المحتوى. ويضح البحث أهمية التسويق والمتاجرة الألكترونية فى
تعظيم عائد دور النشر كما يرسم البحث لهم أسترايجيات لعملية التحول للنشر
الألكترونى.
المـــراجــع:
1-
كتاب
النشر الألكتروني . مركز جمعه الماجد للتراث بدبى بالتعاون مع الأتحاد العربى
للنشر الألكترونى. تحت اطبع، 2009
2-
التكشيف
و الاستخلاص و الإنترنت في المكتبات و مراكز المعلومات. محمد علي العناسوه. – ط.
1. – الاردن، عمان : جدارا للكتاب
العالمي، 2009.
3-
النشر
الإلكتروني و تأثيرة على مجتمع المكتبات و المعلومات : أبحاث و دراسات المؤتمر
العلمي الثاني لمركز بحوث نظم و خدمات المعلومات بالتعاون مع قسم المكتبات و
الوثائق و المعلومات القاهرة، 25-26 أكتوبر 1999 / إعداد و تحرير محمد فتحي عبد
الهادي. - ط.1 . – القاهرة : المكتبة الأكاديمية، 2001.
4-
موقع
شركه جوجل العالميه على شبكه الأنترنت
www.Google.com
5-
توجهات
ترسم مستقبل التجارة الإلكترونية: دراسة عن تأثير التجارة الإلكترونية على الملكية
الفكرية والأمن الإلكتروني. هشام الديب- في: المؤتمر العربي الأول لتكنولوجيا المعلومات
والإدارة. ص 9
6-
النشر
الألكترونى. دليل المشروعات. مجموعه خليفه للكمبيوتر، 2007.
7-
النشره
الدوريه الأولى للأتحاد العربى للنشر الألكترونى. ديسمبر 2007.
8-
النشر
المكتبي الإلكتروني و آفاقه المستقبلية في الجامعات و مراكز البحوث .إيمان فاضل
السامرائي و عامر إبراهيم قنديلجي. – رسالة المكتبة. –مج. 30 ، (أيلول 1995) ، ص.
39
9-
موقع التعيم الألكترونى لشركه أنتل العالميه بإستخدام
تقنيات سكوول Skoool
www.skoool.com